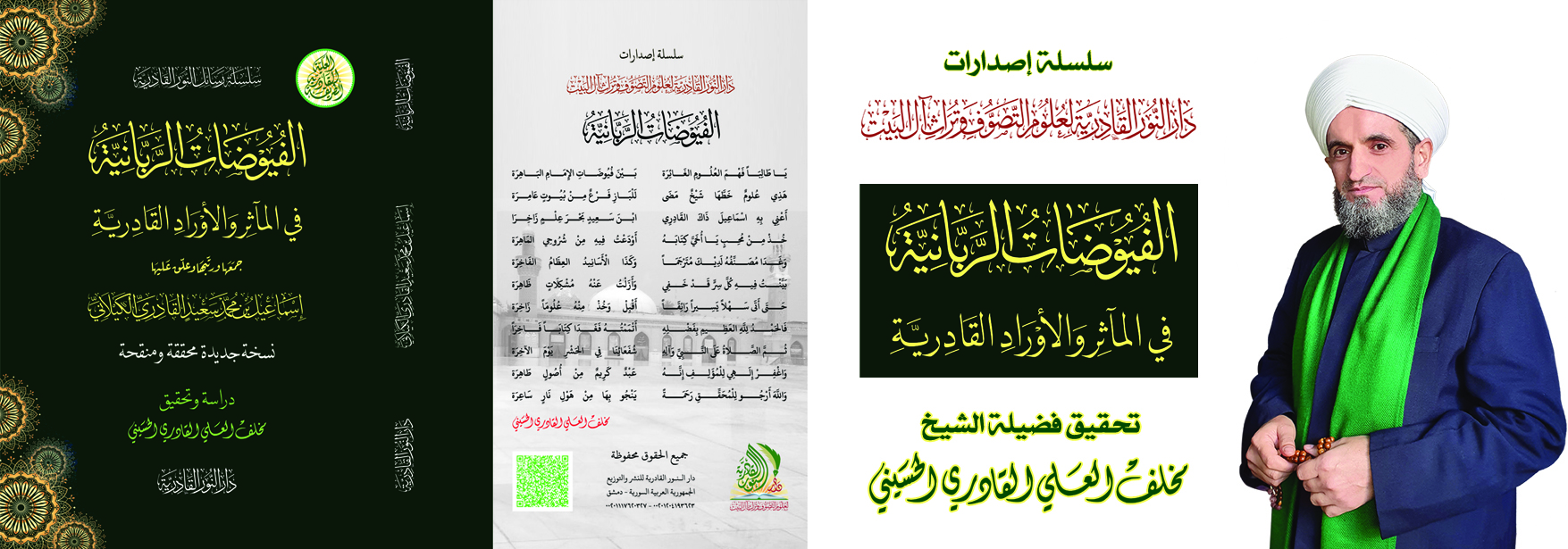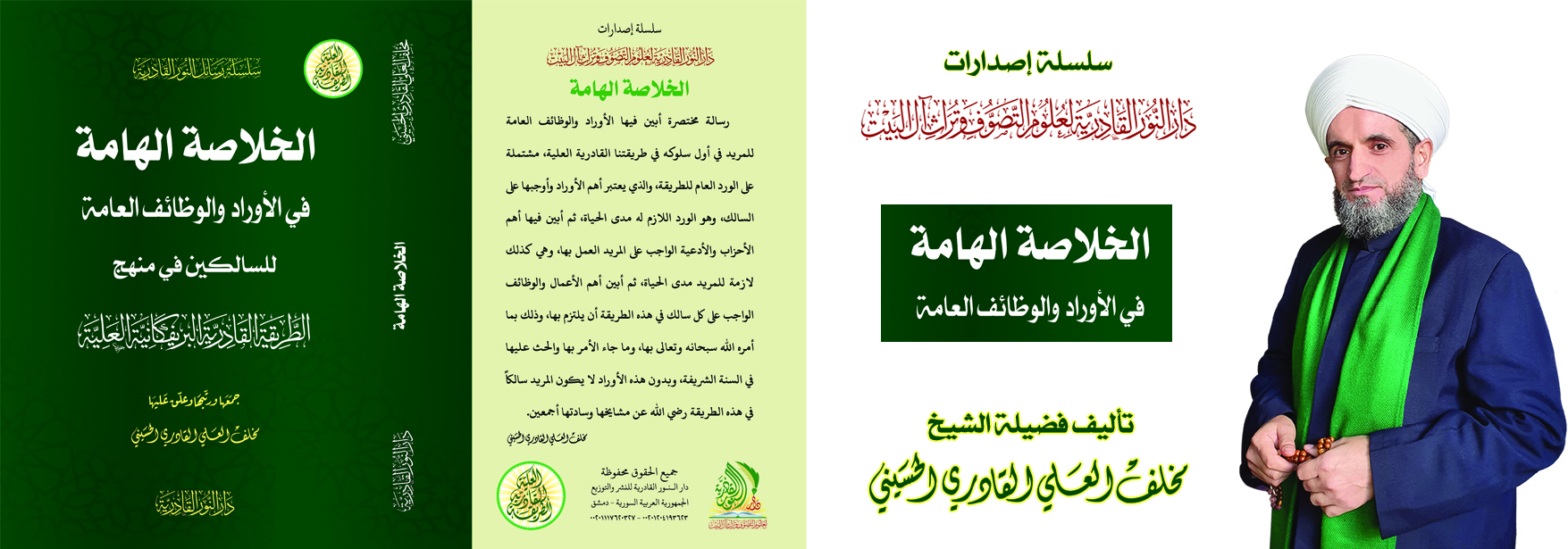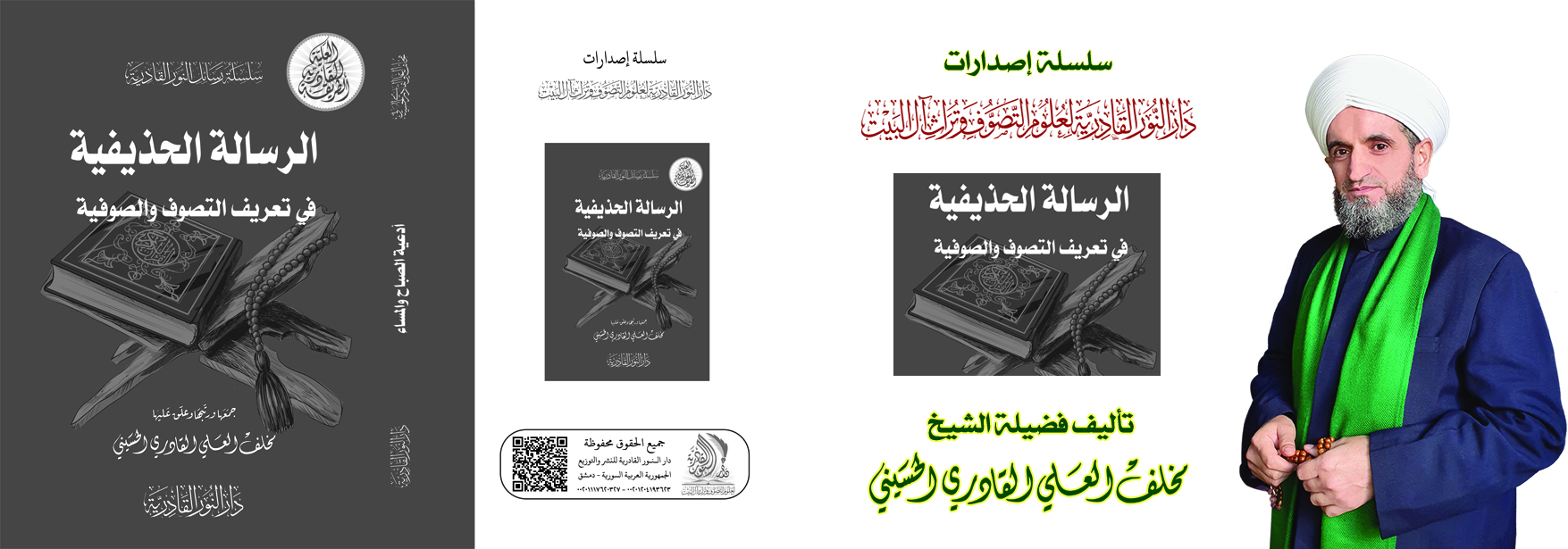تعريف الطريقة القادرية
الكاتب: الشيخ مخلف العلي القادري
الطَّرِيقَةُ الْقَادِرِيَّةُ الْعَلِيَّةُ
الطريقة
القادرية: هي إحدى الطرق الصوفية، وتعتبر من أقدم الطرق الصوفية من حيث إطلاق تسميتها
ونسبتها، ومن حيث تبلورها كمنهج لمدرسة صوفية لها قواعدها وأسسها وأصولها التي
تميزها عن غيرها.
وتعتبر الطريقة
القادرية أقدم الطريق الصوفية من حيث الحقبة الزمنية، وتاريخ النشأة بين الطرق
الصوفية المعروفة في البلاد، وهي طريقة تنسب لمؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني
رضي الله عنه، وسميت بالقادرية نسبة إليه، وقد يسميها البعض بالجيلانية أو
الكيلانية نسبة إليه.
وسنذكر لكم فيما
يأتي تعريف الطريقة القادرية، وهذا التعريف هو من وضعي أنا الفقير إلى الله تعالى،
فأقول وبالله التوفيق:
الطريقة
القادرية هي: «منهج تربوي سلوكي يعنى بتزكية النفس من الرذائل، وتحليتها
بالفضائل، وسلامة القلب من الأمراض، ويتوصل به إلى رضا الله ومحبته، وقائم على
العمل بمقتضى مفهوم التصوف الصحيح، الذي هو مقام الإحسان، وفق الآداب والقواعد
والأسس والأصول التي وضعها مؤسس الطريقة الإمام الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني
رضي الله عنه، ومن جاء من بعده من أئمة ومشايخ الطريقة القادرية الذين ساروا على
منهجه».
وقد أسس الشيخ عبد
القادر رضي الله عنه، طريقته على مجموعة من القواعد والأسس والأصول والآداب
المستمدة من الكتاب والسنة، ومن منهج آل البيت الأطهار والصحابة الكرام، ومنهج
الأولياء والعارفين الذين أخذ عنهم هذه الطريقة المباركة، فهي طريقة مبنية على
الكتاب والسنة
وقد
وضَّح الشيخ رضي الله عنه طريقته فقال في سالكها: «فلا يرى غير
مولاه وفعله، ولا يسمع ولا يعقل من غيره إن بصر وإن سمع وعلم، فلكلامه سمع، ولعلمه
علم، وبنعمته تنعم، وبقربه تسعد، وبتقريبه تزين وتشرف، وبوعده طاب وسكن، به اطمأن،
وبحديثه أنس، وعن غيره استوحش ونفر، وإلى ذكره التجأ وركن، وبه عزَّ وجلَّ وثق
وعليه توكل، وبنور معرفته اهتدى وتقمص وتسربل»[1].
وقد أسس سيدي
الشيخ عبد القادر طريقته على مجموعة من القواعد والأسس والأصول والآداب المستمدة
من منهج الكتاب والسنة، ومنهج العارفين من مشايخه الذين أخذ عنه هذه الطريقة
المباركة.
كما تبرأ من كل
من لا يتمسك بهذه القواعد والأصول، ومن كل ما يخالف الكتاب والسنة.
فقال
في الفتح الرباني: «كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة، طر إلى الحق عز وجل بجناحي
الكتاب والسنة ادخل عليه ويدك في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»[2].
وقد تميز منهجه
بالشدة والأخذ بالعزائم، والمجاهدات وطلب العلم ولزوم الشريعة، وسنبين في المباحث الآتية
أهم القواعد والأصول التي وضعها الإمام وأتباعه، حتى أقاموا مدرسة سلوكية عظيمة
انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها، منذ أكثر من تسعمائة سنة، وما زالت قائمة قوية
ثابتة بمنهجها العظيم.
وكان يعتمد في
تربية المريدين أولاً على الحِلْمِ بهم ومن ثم العلم والفقه والحديث ثم على الزهد
والتقشف والرياضات والخلوات والمجاهدات وعلى الأذكار والأدعية فقام بوضع الأوراد
وقسمها على الأيام والليالي والأوقات فكانت خبرته في التربية ليس لها مثيل في عصره
حتى انتهت إليه رئاسة العلم والتربية في زمنه فلذلك اشتهر بين العوام والخواص وشهدت
له كل الملل والنحل حتى أن اليهود والنصارى كانوا يحضرون مجالسه.
وأشاد بسيرته
ومنهجه وشهد بفضله كبار علماء الأمة وصالحيها ممن عاصروه وممن جاءوا من بعده فمن
العلماء كالعز ابن عبد السلام والإمام النووي وابن كثير والذهبي وابن تيمية وابن
القيم والسيوطي وابن حجر.
ومن الصالحين
كالإمام الرفاعي والشيخ عقيل المنبجي والسهروردي ومحي الدين العربي وعدي بن مسافر
والشيخ رسلان الدمشقي وحياة بن قيس الحراني وأبي مدين وأبي الحسن الشاذلي
والشعراني. ونذكر من أقوالهم على سبيل المثال:
يقول
الشيخ أحمد الرفاعي: « ومن يبلغ مبلغ الشيخ عبد القادر، ذاك بحر الشريعة عن يمينه، وبحر
الحقيقة عن يساره، من أيهما شاء اغترف الشيخ عبد القادر، لا ثاني له في وقتنا هذا»[3].
ويقول
عنه الشيخ علي بن الهيتي: «كان قدمه التفويض والموافقة مع التبري من الحول والقوة، وطريقه تجريد
التوحيد، وتوحيد التفريد مع الحضور في موقف العبودية بسر قائم في مقام العندية لا
بشيء ولا لشيء، وكانت عبوديته مستمدة من لحظ كمال الربوبية، فهو عبد سما عن مصاحبة
التفرقة إلى مطالعة الجمع مع أحكام الشرع»[4].
ويقول
الشيخ عدي بن أبي البركات: «قيل لعمي الشيخ عدي بن مسافر، وأنا أسمع: ما طريق الشيخ عبد القادر؟
فقال: الذبول تحت مجاري الأقدار بموافقة القلب والروح، واتحاد الباطن والظاهر،
وانسلاخه من صفات النفس مع الغيبة عن رؤية النفع والضر، والقرب والبعد»[5].
ويقول
الخليل بن أحمد الصرصري: «سمعت الشيخ بقاء بن بطو يقول: طريق سيدنا الشيخ عبد القادر - رضي
الله عنه - اتحاد القول والفعل، واتحاد النفس والوقت، ومعانقة الإخلاص والتسليم،
وموافقة الكتاب والسنة في كل خطرة ولحظة، ونفس ووارد وحال، والثبوت مع الله عز وجل»[6].
ويقول
شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني: «كان الشيخ عبد القادر متمسكاً بقوانين الشريعة، يدعو إليها وينفر عن
مخالفتها، ويشغل الناس فيها مع تمسكه بالعبادة والمجاهدة، ومزج ذلك بمخالطة الشاغل
عنها غالباً كالأزواج والأولاد، ومن كان هذا سبيله كان أكمل من غيره لأنها صفة
صاحب الشريعة» [7].
ويقول
عنه ابن رجب الحنبلي: «ظهر الشيخ عبد القادر للناس، وجلس للوعظ بعد العشرين وخمسمائة وحصل
له القبول التام من الناس، واعتقدوا ديانته وصلاحه، وانتفعوا به وبكلامه ووعظه،
وانتصر أهل السنة بظهوره، واشتهرت أحواله، وأقواله وكراماته ومكاشفاته وهابه
الملوك فمن دونهم» [8].
ويقول
عنه الإمام عبد الوهاب الشعراني: «طريقته التوحيد وصفاً وحكماً وحالاً
وتحقيقه الشرع ظاهرا وباطناً» [9].
أما
تسمية الطريقة بالقادرية: فلم تكن تسمى بهذا الاسم في زمن الشيخ عبد القادر بل كانت عبارة عن
منهج سلوك وعلم وتربية، تحت مسمى الزهد والتصوف والسلوك، كما هو حال غالب أهل
التصوف، غير أن مصطلح الطريقة قد ظهر وعرف في زمن الشيخ، وقد أطلق الشيخ على منهجه
اسم الطريقة في غير موضع من كتبه، وقد أفرد بابا في كتاب الغنية تحت عنوان: (باب فيما يجب على المبتدئ في هذه الطريقة أولا)، وكذلك
في بعض قصائده، وهذه دلالة على أنه هو من أطلق على منهجه اسم الطريقة في زمنه.
وأما
تسميتها بالقادرية: فقد ظهرت هذه التسمية في القرن السابع الهجري، وذلك نسبة للشيخ عبد
القادر، وصارت كلمة (القادري) تطلق على كل من يتصل نسبه بالشيخ عبد القادر
الجيلاني من ذريته الطاهرة، ثم انتشرت هذه التسمية أكثر لتشمل كل من يتلقى السلوك
والتربية في المدرسة القادرية، والتي أشرف عليها أولاده، وأحفاده من بعدهم، وفق منهج الشيخ وقواعده التي أسس عليها طريقته، ومن أبنائه الذين أشرفوا عليها نذكر الشيخ عبد الوهاب والشيخ عبد الرزاق رضي
الله عنهما، ثم ترسخت التسمية في زمن أحفاده، وظلت تزداد وتنتشر إلى يومنا هذا،
حتى صارت كلمة (القادرية) مصطلحا معروفا لا يخرج عن معنيين:
الأول: ذرية الشيخ عبد
القادر الجيلاني رضي الله عنه.
والثاني: مشايخ المدرسة القادرية
وتلاميذها وأتباعها، ثم أطلق بعد ذلك عليهما معا، سواء ذرية الشيخ عبد القادر، أو
المنتسبين لمنهجه.
ثم بعد ذلك
تبلورت التسمية بشكل واضح وكامل بعد افتتاح الزوايا القادرية وانتشارها على يد
أحفاده، وأول من بدأ بهذا هم أبناء الشيخ عبد العزيز، وأول من افتتح تكية وزاوية
قادرية هو الشيخ "عثمان القادري" ابن الشيخ عبد العزيز الكيلاني المتوفى
سنة: (623هـ)، ثم صارت سنة لهذا المنهج، فأقبل الأشراف والسادة القادريون على افتتاح التكايا والزوايا التي يتجمع فيها المنتسبون لها، وكلها تتصل مباشرة
مع المدرسة القادرية ببغداد، أو بجبل سنجار في أيام الغزو المغولي، وصار يطلق
عليها اسم القادرية، ثم توسعت لتنتشر في غالب البلاد وذلك نتيجة لانتشار الذرية
القادرية في البلاد، بسبب الحروب والتهجير، وبسبب انتشار المجازين بهذه الطريقة في
البلاد.
أما
أصل نشأتها: فإن أردنا الحديث عن أصل الطريقة القادرية وأصل نشأتها، وكذلك سائر الطرق العلية، فإن أصلها
يرجع إلى صدر الإسلام، إلى شريعة سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم،
الذي جاءنا بالشريعة من الله، فكل الطرق ترجع إلى ذلك الأصل العظيم، وكل الطرق
الصوفية ترجع بأسانيدها إلى عصر النبوة، فلا فرق بينها أبدا، وهي موجودة منذ ذلك
العصر وامتدت واستمرت إلى عصر التابعين ومن جاء من بعدهم حتى وصلت إلينا، مع العلم
أنها لم تكن تسمى بأسمائها التي نعرفها بها الآن، وعرفت بأسمائها فيما بعد، وسميت
كل طريقة نسبة إلى مجددها ومؤسسها وإمامها الذي استطاع أن يضع لها الأسس والآداب
والتعاليم مستمدا ذلك من الكتاب والسنة، ومن حياة آل البيت الأطهار والصحابة
الكرام، ومن منهج الأولياء والعارفين الذين أخذ عنهم طريقته، فنسبت إليه، وما هو
إلا حلقة من سلسلتها الشريفة المتصلة بسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن
بهذا الكلام إنما نقصد منهج الطريقة المتمثل بالآداب والتعاليم التي تتضمنه.
وأما
سندها: فقد تلقى الشيخ عبد القادر عن الشيخ أبي سعيد المبارك المخزومي، عن
الشيخ علي الحكاري، عن الشيخ أبي فرج الطرسوسي، عن الشيخ عبد الواحد التميمي، عن
الشيخ أبي بكر الشبلي، عن الشيخ الجنيد البغدادي، عن الشيخ سري السقطي، وهو عن
الشيخ معروف الكرخي، عن الشيخ داوود الطائي، وهو عن الشيخ حبيب العجمي، وهو عن
الشيخ الحسن البصري، عن زوج الزهراء البتول، وابن عم الرسول سيدنا ومولانا حضرة
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه ورضي الله عنه[10].
وللشيخ معروف
الكرخي سند آخر وهو ما يعرف بالسلسلة الذهبية: عن الإمام علي الرضا، وهو عن أبيه الإمام موسى الكاظم، وهو عن أبيه الإمام
جعفر الصادق، وهو عن أبيه الإمام محمد الباقر، وهو عن أبيه الإمام علي زين
العابدين السجاد، وهو عن أبيه الإمام أبي عبد الله الحسين، عن أبيه زوج الزهراء البتول،
وابن عم الرسول سيدنا ومولانا حضرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
وكرم الله وجهه ورضي الله عنه.
وللشيخ رضي الله عنه أسانيد أخرى لا
مجال لذكرها ها هنا.
المصدر: الكنوز النورانية من أدعية وأوراد السادة القادرية
ص (37)